 محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
لازال الحديث مستمراً حول إشكالية مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفى، فمن وقت لأخر تطفو على السطح أزمات "الطلاق الرجعى" أو مراجعة الزوجة بعد طلاقها، وهو الأمر الذى يتسبب في مشاكل حول الإرث بين الورثة، حيث تعُج المحاكم بمثل هذه القضايا بين الورثة، و"الطلاق الرجعي" هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الأشهاد ولا ترفع أحكام النكاح، وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.
وهنا لابد من التفريق بين آمرين مهمين جداً عند النظر في إشكاليات الطلاق الرجعى هل فعلاً الطلاق كان رجعي، فيجوز للزوجة المتضررة لها إقامة دعوي إثبات الرجعة أم أنه طلاق بائن لأن الطلاق البائن بعقد ومهر جديدين فيكون التكييف الصحيح دعوي إثبات زواج وليس رجعة، مع الأخذ في الإعتبار أن الزوجة المتضررة في كثير من الأحيان تُقيم دعوى إثبات الرجعة، ويتم رفضها جزئى واستئنافي والتماس إعادة النظر.

مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفي
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفي، من حيث الشهادة، وشروط صحة الإقرار بالزواج، والنكول عن اليمين، والمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات الزوجية، وتعريف الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد أو مهر، وبدون رضا الزوجة، والرجعي يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فبمجرد طلاقه إياها فإنّها تبين منه، ولا تكون له عدة عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار.
إثبات الزواج العرفى وإثبات الزواج في المذهب الحنفي
يثبت الزواج في الفقه الحنفي بأحد الأدلة الآتية:
أولاً: الشهادة
والشهادة في المعنى الاصطلاحي إخبار في مجلس القضاء عما وقع تحت سمع شخص و بصره مما يترتب عليه أثر في الشرع والقانون ، أي إخبار الانسان في مجلس القضاء بحق عل غيره لغيره، ونصاب الشهادة في إثبات الزواج شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول – وفقا لـ"ميزار".

والبينة حجة متعديه
فالثابت بها ثابت على الكافة ولا يثبت على المدعى عليه وحده، و يشترط في الشاهد: العدالة والبلوغ و الحرية والإبصار وألا يكون محدوداً في قذف، وألا يكون متهماً في شهادته، بأن كان يجر لنفسه مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً، و يدخل في ذلك ألا يكون الشاهد من أصول أو فروع المشهود له أو زوجاً له، و العلم بالمشهود به، ذاكراً له وقت الأداء، والقدرة على التمييز بالسمع والبصر بين المدعى والمدعى عليه – الكلام لـ"ميزار" .
وقد أجيزت الشهادة بالتسامع استحساناً في بعض المسائل، منها إثبات الزواج، وذلك دفعاً للحرج و تعطيل الأحكام، بحيث أنه إذا اشتهر الزواج لدى الشاهد بأحد طريقي الشهرة الشرعية حل له أن يشهد به لدى القاضي، والشهرة الشرعية تنفسم الى قسمين: شهرة حقيقية، وهذه تكون بالسماع من أقوام كثيرين لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشترط فيهم العدالة، وشهرة حكمية، وتكون بشهادة عدلين أو رجل عدل وعدلتين بالشئ بلفظ الشهادة، وهذا هو الرأي المفتى به في المذهب.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن: "العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش، إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهادة الحقيقية أو الحكمية، فمن شهد رجلاً و امرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان باللفظ الشهادة انها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد"، طبقا للطعن رقم 12 لسنة 36 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 27 مارس 1968 .
ثانياً: الإقرار:
الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه، و إذا أقر الشخص بحق لزمه، ويعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر، ولا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية – هكذا يقول "ميزار".

ويشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي:
1- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
2- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
3- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
والإقرار بالزوجية صحيح ونافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص 127)، وذهب الصاحبان إلى أنه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة، أما الإمام أبوحنيفة، فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل، فإنه يصح وينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها، فلا تثبت به الزوجية ولا يستحق به الميراث، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقب وفاتها وبأربع سواها ولا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه أما بعد موت الرجل فالزوجية أحكام باقية كالعدة، ولذلك يحل لها أن تغسل زوجها – طبقا للخبير القانونى.
ثالثاً: النكول عن اليمين:
إذا لم يقر المدعى عليه بالزوجية، ولم يقدم المدعي بينة عليها ، أو على أن المدعي عليه قد أقر بها قبل ذلك، كان له – على رأي الصاحبين المفتى به – أن يطلب من القاضي تحليف المدعى عليه، فإن حلف رفضت الدعوى ، و إن نكل ثبت الزواج، لأن النكول إقرار بالمدعى به عندهما، وذهب أبو حنيفة إلى أن اليمين لا توجه إلى المدعى عليه إذا كان أحد الزوجين، وإذا وجهت إليه لم يثبت الزواج بنكوله، لأن النكول بذل لا إقرار عنده، والزواج ليس مما يبذل، هذا، وإذا قضي برفض الدعوى بعد أن حلف المدعي عليه أن ليس بينه و بين المدعي زوجية، كان هذا القضاء قضاء ترك لا يمنع المدعي من تجديد الدعوى إذا وجد البينة.
والمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات الزوجية:
فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، ونص في المادة الثالثة منه على أن: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادربالقانون رقم 1 لسنة 2000 ...."، وبذلك يكون المشرع قد عقد لمحاكم الأسرة الاختصاص النوعي بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ولم يعد هناك وجود لمحاكم جزئية وأخرى ابتدائية في نطاق منازعات الأحوال الشخصية، و بناء على ذلك يضحى الاختصاص بنظر دعوى إثبات الزوجية معقود لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظرها.
تحديد الدعاوى التي لا يسري عليها القيد:
هناك من الدعاوى ما لا يسري عليها القيد الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 و الخاص بعدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، لكون الحقوق فيها ليست الزوجية سبباً مباشراً لها، أي ليست ناشئة عن عقد الزواج، و هناك نوع آخر من الدعاوى لا يسري عليها هذا القيد استثناءً من القانون نفسه بنص المادة المذكورة سلفاً، وبيان كلا النوعين على الوجه التالي:
الدعاوى التي لا يسري عليها القيد بغير نص: من هذه الدعاوى:
1- إثبات الإرث بسبب البنوة: لأن الإرث هنا سببه البنوة و ليس الزواج، فقد قضت محكمة النقض بأن: "لما كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى ارث بسبب البنوة، و هي دعوى متميزة عن دعوى اثبات الزوجية أو اثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سباً مباشراً لها، فإن اثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الاسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة، ولما كان اثبات البنوة وهو سبب الارث في النزاع الراهن بالبينة جائزاً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى"، طبقا للطعن رقم 21 لسنة 44 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 7 أبريل 1976 .

ملحوظة:
وعلى ذلك فيمكن للولد من زواج عرفي أن يرفع دعوى إرث من أبيه دون أن يكلف تقديم وثيقة رسمية بالزواج، وإنما يكفيه البينة على دعواه، هذا ويلاحظ أن دعوى الإرث التي ترفعها الزوجة عن زوجها المتوفي من زواج عرفي لا تقبل لأن مبناها الزوجية .
2- دعوى نفقة الأولاد: الأصل في الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون النسب قائماً فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة، أخذاً بأن سبب وجوب النفقة للأولاد هي الجزئية النابعة من كون الفرع من صلب الأصل (الطعن رقم 173 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 26/5/1997 )، وبالتالي لا تعد الزوجية سبباً لوجوب النفقة للأولاد على أبيهم، وإنما السبب في وجوبها هو كون الولد جزء من أبيه و فرع منه أي البنوة، الأمر الذي تكون معه دعوى الولد من زواج عرفي بطلب النفقة من أبيه مقبولة ولا تخضع للقيد الوارد بنص المادة 17 لكونها ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، و يلاحظ أن نفقة الصغير تشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج والتعليم، فالدعوى بأيهم مقبولة، وعليه فتكون المطالبة بمسكن حضانة للصغير مقبولة باعتباره من النفقة ، و هكذا في كل مشتملات النفقة.
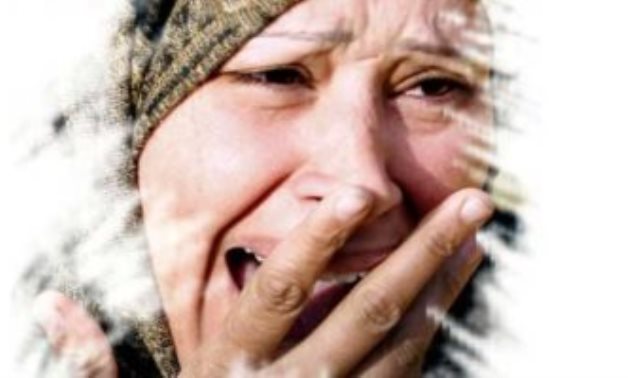
3- إثبات الزوجية التي من شرائط امتداد عقد الإيجار:
فقد قضت محكمة النقض بأن : (الأصل في فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج، إلا أن المشرع تدخل استثناءً من هذا الأصل – احتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية – فقد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار............."، ولما كانت دعوى الطاعن هي طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع باعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة للمستأجر الأصلي الذي ترك العين لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج، وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن الزوجية التي هي من شرائط امتداد عقد الايجار عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة )، الطعن رقم 1535 لسنة 48 ق – جلسة 19 /5/1982، والطعن رقم 973 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/12 /1984 .
هذا، ويجب التنبه إلى ما سبق الإشارة إليه من عدم خضوع النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية للقيد الوارد بالمادة 17 وفقاً لما انتهت إليه محكمة النقض، وبالتالي فالنزاع في الزواج إثباتاً وصحة و خلافه أصبح طليقاً من القيد المذكور، وقد أكدت محكمة النقض في حكم حديث لها هذا الأمر، حيث أجازت اثبات وجود أو صحة الزواج ذاته عند الإنكار بكافة طرق الإثبات، فقد قضت بأن:
"القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصرعلى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية، فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية"، طبقا للطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005.

وفي الفترات الأخيرة انتشر الزواج العرفي لأسباب لا حصر لها
ويضيف "ميزار": فوسط بحر لجي من ظلمات السلوكيات والأخلاقيات في مجتمعنا وضعف الإيمان في قلوب الناس وذبول الضميرو انتشار الفساد كان لزاماً أن ينتج عن ذلك موجات من عواقب السوء جزاءً وفاقاً، فكان أن طفى على السطح ما يسمى بالزواج العرفي، حيث أُلْبِسَ الحقُ ثوبَ الباطل، فالزواج العرفي في حقيقته الأصيلة زواج مستوفي لأركان و شروط الزواج الشرعي غير أنه لم يسجل أو يوثق لدي الموظف المختص بإبرام عقود الزواج فهو بذلك حق ولجأ إليه البعض بوصفه هذا لأسباب لا تخل بصحته وبحسن نية فكانت علاقاتهم شرعية صحيحة غير أن خراب الذمم.
وضياع القيم أسفر عن نفوس مريضة وخبيثة اقتلعت من الزواج العرفي مضمونه الحق، واتخذت من اسمه ستاراً لتبث من خلاله أغراضها الجنسية الأثيمة فقط، وتحقيق مصالح خاصة غير مشروعة و بغير نية حقيقية في الزواج و كان أمراً مقضياً أن يلازم هذه الأغراض اخفاؤه عن الأعين والآذان فوُجِد زواج بغيرشهود وبغير إعلان ولا علم به إلا لطرفيه فقط، ووُجِد زواج آخر بشهود و لكن تم استكتامهم – وهكذا - فكانت آثار كل ذلك ضارة بأطرافه وبالمجتمع، بل وبثمرة هذه العلاقات وهم الأولاد، الأمر الذي لم يجد معه المشرع الوضعي مناصاً من التدخل التشريعي للتصدي للزواج العرفي – حلاله و حرامه – منعاً لمضاره ومفاسده، ونظراً لخطورة موضوع الزواج العرفي على الأسرة و المجتمع، وانتشاره في الآونة الأخيرة وتكاثر الندوات والمؤتمرات في محاولة لمناقشته وإيجاد حلول له.
ومن أسباب اللجوء للزواج العرفي:
لجوء الزوجة التي توفي زوجها ولها منه ولد واحد لم يصل لسن التجنيد وترغب في الزواج بعده إلى الزواج العرفي في محاولة منها لحصول ابنها على الإعفاء من الخدمة العسكرية لكونه العائل الوحيد لها، وكذا في حالة رغبة الزوجة المتوفي عنها زوجها وتستحق عنه معاشاً إلى هذا الزواج للحفاظ على استمرار استحقاقها للمعاش .
أسباب قانونية: ومنها:
ما منحه القانون للمطلقة الحاضنة من حق في الإستقلال بمسكن الزوجية هي ومحضونها، ونظراً للعجز الواضح عن توفيرالمسكن، وهروباً من هذا الإلتزام إذا تحقق موجبه يلجأ الرجل إلى الزواج العرفي .
إجازة تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها دون ولي، عملاُ بمذهب الإمام أبي حنيفة
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في ذلك بأنه:
"ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج و الزوجة ) بنفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما و قيول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، و يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الجقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد رسمياً أو كتابته بورقة عرفية، و هذا كله من الوجهة الشرعية، أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، و إنما اشترط ذلك لسماع الدعوى.... " - فتواها بتاريخ 1/2/1957 في الطلب رقم 582 لسنة 1963 – مشار إليها بمؤلف المستشار البكري – الكتاب الأول – ص 131 .
وقد وضع الدستور
قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية، بألا تناقض مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثايتة – مصدراً و تأويلاً – والتي يمتنع الإجتهاد فيها، ولا يجوزالخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الإجتهاد تنحصرفيها و لا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان و المكان لضمان مرونتها و حيويتها، وإذا كان الإجتهاد في الأحكام الظنية و ربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية حقاً لأهل الإجتهاد.
المقاصد الكلية للشريعة
فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولي الأمر ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الإجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية و القواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل و العرض والمال مستلهماً في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها ومن ثم كان حقاً على ولي الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثماً من القواعد واجبة التطبيق في القانون، قاعدة "الغش يبطل التصرفات حتى ولو لم يجرمها نص خاص".
يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن، ولمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصره، وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، حيث إن تلك القاعدة الأصولية تعد قاعدة قانونية سليمة، تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية، في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما لصيانة مصلحة الأفراد والجماعات.
دعوي إثبات الرجعة يتوقف على إذا كان الطلاق رجعي أم طلاق بائن
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصري، ولكل الشرائع، أن الغش يفسد كل شيء، ولا يجوز أن يفيد منه فاعله، منعا للفساد ودعما لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم، أن تتخذ سبيلا للانحراف، كما نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه (يترك للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم.
ووفى الأخير يقول "ميزار": حيث أن البين من وقائع النزاع المطروح مضي أكثر من 6 سنوات على وفاة الفنان لإقامة دعوي إثبات الرجعة وبعد إشهار الإرث والوفاة، وأن دعوي إثبات الرجعة يتوقف على إذا كان الطلاق رجعي أم طلاق بائن، فإذا كان الطلاق بائنا كان يتوجب إقامة دعوي إثبات زواج، لأن الطلاق البائن يكون بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الطلاق رجعيا فدعوي إثبات الرجعة هي التكييف الصحيح للتداعي، ولكن مانتهت اليه المحكمة في حكمها يتوقف علي مدي توافر الأدلة والقرائن من عدمه والتي ترقي الي مرتبة الدليل وتوافر الشهود وصحة النصاب ومدي اطمئنان المحكمة لتلك الشهادات، وفي النهاية فإن الحكم وفقاً لما انتهي اليه يمثل عنوان الحقيقة.
